
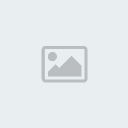
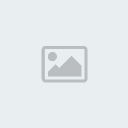
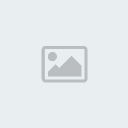
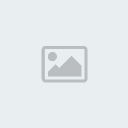
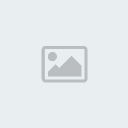
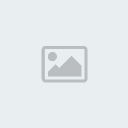
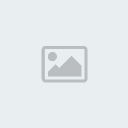
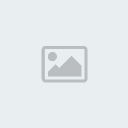 المصدر...
المصدر...
د.سمير زيدان الجامعة اللبنانية – كلية التربية
مدرّب في المركز التربوي لأساتذة التعليم الثانوي مبحث الذاكرة و التخيل
مبحث الذاكرة و التخيل 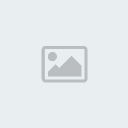
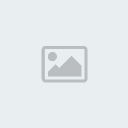
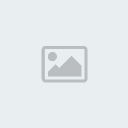
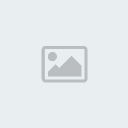
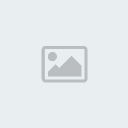
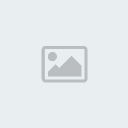
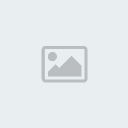
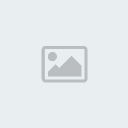
الذاكرة هي وظيفة نفسية تحفظ المادي وتسترده في حدود فترة زمنية معينة.
ويستوقفنا الكلام على الذاكرة للتأمل في معنى الزمان؛ فهو معنى ملازم
لوجودنا نَقْدر على الإحساس به أكثر من تعريفه، لأنه يُعرَّف بذاته؛ فهو
صيرورة وتغير وتقدم وقبل وبعد؛ وخاصيته الأساسية هي لا معكوسيته.
إن وجودنا الحاضر هو شعورنا بديمومتنا بين ماض انقضى ومستقبل منتظر. لكن
الوعي من منطلق حاضره يسيطر على الماضي والمستقبل، فقد قال “هيدغر
Heidegger” الإنسان هو كائن الأبعاد. فإنه يُسقط المستقبل في الحاضر، ويدمج
الحاضر بالماضي، فتكون الديمومة مسرح التذكر والتخيل.
وتطارد الذاكرة أحداث الماضي المتقهقرة مضفية عليها نوعًا من الثباتية لتضعها تحت مجهر الوعي لتعرفها، لا لتعيشها من جديد.
وقد عرَّف “لالند Lalande” الذاكرة فقال: “إنها وظيفة نفسية تسترجع حالة
وعيناها في الماضي مع علمنا أنها تخص الماضي فقط”. هذا يعني أننا في مجال
التذكر نعيد صلتنا بماضينا ونعرف تمامًا أن هذا الماضي قد انتهى.
تثبيت الذكريات:
نحن لا نثبت جميع إدراكاتنا وتجاربنا، بل إن هذه العملية تخضع لخيار.
ونتوقف عند نوعين من العوامل المؤثرة في تثبيت الذكريات: موضوعية وذاتية.
- العوامل الموضوعية:
يرى أنصار علم النفس الشكلي أن بنية الشيء أو الفعل هي التي تجعله من جملة
الذكريات؛ فإن نغمًا موسيقيًا يثبت في الذاكرة أكثر من أصوات متنافرة
وغير منتظمة؛ وتكون الأفضلية في الحفظ لقصيدة موزونة لا لسلسلة كلمات غير
مفهومة وغير متلائمة، وباختصار فإن الشكل الأفضل والأكثر تأثيرًا في
مسرح الإدراك هو الذي يثبت في الذاكرة.
- العوامل الذاتية:
إن قِيَم الأشياء، واستجابتها لرغباتنا وميولنا وثقافتنا هي التي تساعد
بالفعل على تثبيت الأشياء في الذاكرة؛ فالنغم الموسيقي المنسجم، والصورة
المنتظمة، والقصيدة الموزونة تثبت في الذاكرة بقدر ما تثير انفعالاتنا
الغنية وأذواقنا وتتلاءم مع تجاربنا.
الواضح إذًا أن اكتساب الذكريات وتثبيتها ليس عملاً آليًا ولا مجرد إسقاط
من الخارج للصورة الأقوى كما يدعي علماء النفس الشكلي، بل هو فعل حي
مرتبط بعوامل شخصية. فليست الذاكرة كمستودع يصب فيه كل حادث من دون
تمييز، بل هي فعل الشخص الذي يُرَكِّز الأحداث ويُثبِّت الصور والمواقف
والكلمات من خلال حاجاته وهمومه وقيمه ومفاضلاته الواعية وغير الواعية.
مسألة اختزان الذكريات
نظرية ريبو:
يعتبر ريبو أن الذاكرة شأنها شأن سائر الأحداث النفسية هي ذات طبيعة فيزيولوجية. ولكن هل يمكن أن نرد الذاكرة إلى مسار فيزيولوجي؟
في كتابه المعروف بأمراض الذاكرة. يحاول “ريبو” أن يبرز القضايا الأساسية
في الذاكرة وفي حفظ الذكريات فيقول أن الذاكرة بجوهرها حدث بيولوجي
وبالعرض نفسي، معتمدًا في ذلك على أن الذاكرة مقيدة ومشروطة بالطرق
العصبية وتغيراتها. فالذاكرة ترتد إذًا إلى قاعدة فيزيولوجية محضة.
والذكريات تنتظم بالضبط على شكل أفعال نمارسها عبر العادة من خلال
الاتصالات العصبية التي لا يضيف لها الوعي أية إضافة.
والذكرى حسب “ريبو” هي حدث عضوي وتختزن ماديًا وبصورة كاملة في الدماغ.
فالذكرى هي إذًا أثر مادي، أما آلية التذكر وطريقته في تشبه آلية اشتغال
الفونوغراف حيث تقوم الإبرة على الأسطوانة بايقاظ الأصوات التي تكون مخفية
في الأثلام. ويعزّز ريبو طرحه من خلال شواهد مستقاة من أمراض الذاكرة: كل
جرح دماغي يؤدي بالضرورة إلى فقدان الذكريات الخاصة بالمنطقة الدماغية
المصابة. إن الجرح في منطقة بروكا، التلفيف الثالث من الجهة الدماغية
اليسرى، يؤدي على سبيل المثال إلى اختفاء الذكريات الكلامية المحكية
والمنطوقة.
بهذا الشكل فإن مختلف الذكريات السمعية والبصرية والحركية تتمركز جميعها
في الدماغ بشكل محدد وفي مناطق خاصة بها. لذلك فقد ركزت نظرية ريبو على
أن الذكرى تختزن على شكل أثر مادي في الدماغ. أما النسيان فهو الغياب
الجزئي أو الكلي لهذه الآثار المادية.
نخلص من كل هذا على أن الذاكرة عند ريبو تتآلف مع العادة التي تتخذ
أشكالاً أكثر أو أقل آلية. فالذاكرة تغرز بجذورها داخل الحياة العضوية.
نقد لنظرية ريبو:
دون أدنى شك، إن الجهاز العصبي يلعب دورًا مهمًا في عملية التذكر. لكن من
واجبنا أن لا نقر بكل المسلمات الفيزيولوجية التي يطرحها ريبو لأن
التجارب تبين أن الجرح الدماغي لا يتلف الذكرى بل يجعل إمكانية استدعاءها
واسترجاعها مستحيلة.
والواقع أن تفسير عملية التذكر بالترابط الآلي على غرار العادة يبدو أمرًا
مرفوضًا خاصة وأن البعض يرى أن العادة بحد ذاتها ليست آلية عمياء بل
تتميز بشيء من المرونة. ومن هذا المنطلق في فهم العادة تصدى برغسون في
كتابه المادة والذاكرة (matière et mémoire) للرد على نظرية ريبو
المادية.
نظرية برغسون الروحانية:
ينتقد برغسون ريبو لأنه خلط بين الذاكرة والعادة: فالعادة هي تركيبة جسدية
تابعة لارتباطات جسدية عصبية عضلية بينما الذاكرة الحقيقية هي شيء آخر.
فأنا عندما أحفظ قصيدة عن ظهر قلب عبر التكرار فإن هذا هو فعل العادة.
ولكن عندما أستدعي المراحل المختلفة التي مرّ بها تعلمي وحفظي للقصيدة،
أي عندما أميز كل مرحلة من هذه المراحل بفردانيتها، فإن هذا يكون عين
التذكر.
علينا أن نميز إذًا حسب برغسون، بين تعلم واكتساب الدرس الذي هو عادة، أي
آلية تبرمج الجسد من خلال التكرار، وبين الذكرى لكل قراءة قرأناها على
حدة، أي تلك الأفعال المتموضعة زمانًا وليس في الجسد. فالذكرى إذًا عند
برغسون ليست في العمق سوى اللحظة الزمانية الفردانية الأصلية التي لا يصح
نسبتها إلى وجودنا الحسي. فبينما العادة تستخدم الماضي فإن الذاكرة
تتمثله وتتخيله بكل ملامح الماضي من دون علاقة مع الفعل. فالعادة هي فعل
والذاكرة هي تأمل أي إعادة انبعاث الماضي.
ولكن أين وكيف تحفظ الذكريات؟
يتبنى برغسون دون تردد الموقف الروحاني وبالنسبة لهؤلاء الروحانيين فإن
الطاقة الروحية هي حقيقة أو واقع لا يمكن تدميره، لذلك فإن برغسون يجعل
الذاكرة من طبيعة روحانية شأنها في ذلك شأن الحياة النفسية الداخلية. وهي
بالتالي غير قابلة للضياع أو للفقدان لأنها غير متمركزة في أي جزء من
أجزاء الجسد. ينتج عن ذلك أن الماضي يحتفظ به كاملاً في الذاكرة:
“فحياتنا الماضية حسب برغسون هي هناك، في موضع غير مادي، ولكنها محفوظة
بكامل تفاصيلها”.
ولكن هل يتم اختزان الذكريات بصورة واعية أو لا واعية؟
يجيب برغسون أن اختزان الذكريات يتم بصورة لا واعية إذ أن الوعي لا يختص
إلا بالحاضر. فكل ماضينا حسب برغسون يقبع في حالة اللاوعي، تحت شكل ذكريات
محضة مجرّدة من المادة، إلاّ أن تحولها إلى حيز الفعل والوعي لا يتم إلا
بمداخلة الجسد. فالجسد ليس هو الذي يحفظ أو يولد الذكريات، بل هو يؤمن
الوسيلة لإلباسها لباسًا ماديًا، فيعمل على تثبيتها لتعود وتظهر إلى حيز
الوعي.
إن نظرية برغسون هي أكثر ملاءمة مع علم الأمراض العصبية من نظرية ريبو.
فمن واجبنا الاعتراف بأهمية التفسير الذي قدمه برغسون حين أكد عدم صلاحية
ردّ الذاكرة إلى طبيعة فيزيولوجية محضة. لقد شدّد برغسون على الاختلاف
البيّن ما بين العادة والذاكرة الحقيقية. لقد كان من الأوائل الذي بيّنوا
أن الذكريات ليست مختزنة في الدماغ كما تختزن الكلمات في كتاب، وهذا ما
أشاد به الدكتور دولاي (delay) بقوله: إن كل الأحداث التي نكتسبها تذهب
لتوافق اتجاه الطرح البرغسوني.
بالرغم من ذلك لا بدّ من الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها نظرية
“برغسون” وبالفعل فقد تم توجيه العديد من الانتقادات الجدّية لهذه
النظرية. إن مفهوم ذكرى غير مادية روحانية صرفة خالصة يبقى مفهومًا
ملتبسًا عند برغسون من خلال كتابه المادة والذاكرة (matière et mémoire).
نقد لنظرية برغسون:
إن ردّ الذكريات إلى اللاوعي (القمع المقلوب) لا يمكن أن يكون كافيًا. إن
مفهوم ذكرى خالصة قابعة في اللاوعي ليس سوى شكل من أشكال الوهم التخيلي
الذي يصعب القبول به. بكلام آخر فإن نظرية اختزان الذكريات كاملة في هذا
اللاوعي تبدو تناقضية. فالتجربة الإنسانية تكذبها حيث أن قسمًا محدودًا من
الذكريات يبقى في ذاكرتنا، بينما يضعف أو يتلاشى قسم آخر من هذه
الذكريات. لذلك فإن فرضيته عن النسيان تبدو فرضية خاطئة إذ النسيان لا
يرتد فقط إلى عدم إمكانية الاستعادة.
يلتقي برغسون وريبو في خطأ واحد هو أن الذكريات تحفظ كأشياء. فهي آثار
مادية محفوظة في الدماغ على رأي ريبو، أو صور روحية محفوظة في لاوعي غير
محدد حسب برغسون. وفي النظريتين تكون الذكريات كصور عن أحداث معاشة في
الماضي. فهي باختصار انعكاسات سلبية أو بقايا إدراكاتنا السابقة.
ولقد قدمت الفلسفات المعاصرة حلاً مختلفًا حين أكدت أن ما يحتفظ به ليس
(حالات الإدراكات السابقة) بل إن ما يحتفظ به يحمل صفة الحاضر وينطبع
بطابعه مبتعدًا بذلك عن الماضي وهمومه.
يقول ميرلوبونتي: إن الإدراك المختزن يستمر في التواجد الحاضر ولا يفتح
أمام الشخص أبعاد الهروب من الحاضر والغياب في طيات الماضي. لذلك فإن
إشكالية حفظ الذكريات يبدو أنها مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن الذكريات لا
يمكن بشكل من الأشكال أن تكون كأشياء مختزنة لا في الدماغ ولا في اللاوعي.
مسألة إعادة بناء الذكريات وتطورها:
انبعاث تلقائي؟ أم إعادة بناء من منظور الحاضر؟
إن علم النفس الحديث يقرّ بفضل الفلسفة الظواهرية التي تفسر الذكرى على
أنها فعل. والفعل لا يحتفظ ولا يختزن. فالذكرى يُعاد بناؤها من منطلق
اللحظة الحاضرة، حيث نعيش الحاضر ونعترف بالماضي أنه ماضينا الذي انقضى
وولّى.
والاعتراف بامتلاك الماضي هو ما يميِّز الذاكرة. ولكي تكون الذكرى أصيلة
لا يكفي أن يعاد إحياء الماضي، بل ينبغي الاعتراف بأن هذا الماضي قد مضى
وانقضى. وهذا الاعتراف يظهر بأشكال متعددة أعلاها هو أن الماضي ليس
معاشًا وتابعًا للعواطف عند الفرد بل هو تابع لمستوى العقل والفكر.
فالتذكر هو فعل توليف (Synthèse) وتجميع عقلي.
وبالفعل فإن الإنسان يلقي بظلال شخصيته على المكان والزمان في آن معًا.
هذا يعني أنه ليس بإمكاننا أن نعي ماضينا كما هو في واقعه بل نحن نعيه
ونفهمه من خلال شخصيتنا، أي من تلك اللحظة التي نباشر فيها عملية
استعادته.
وإذا ما اقتنعنا بوجهة علم النفس الحديث بأن الذاكرة لا تحفظ ولا تختزن لا
ماديًا ولا روحانيًا فكيف بالإمكان إعادة بناء الذكرى؟ أوَ ليس من
الضروري وجود بعض المساعدات (مساعدات التذكر) لإعادة إنتاج الذكرى؟
في الواقع أن إعادة إنتاج الماضي هو عملية معقدة تدخل فيها جميع العناصر
النفسية والجسمانية الفيزيولوجية والاجتماعية. ولكي نتذكر موضوعًا ما
علينا أن نضعه على مسافة منا ونجعله بين ركيزتين: أي ما قبله وما بعده،
هذا يعني أننا نموضع الذكرى في المكان بين حدثين مهمين من أحداث حياتنا.
في هذه الحالة فإن إعادة بناء الماضي تتم عبر وساطة ما يسمى بنقاط
الارتكاز (point de repère).
كذلك فإن إعادة بناء الماضي تخضع للعوامل التالية:
أ- البعد العقلي:
الذكرى لها طابع عقلي ذو أهمية قصوى فالذكرى تختلف كثيرًا عن الصورة
المتخيلة وعن الإدراك وعن الشعور أنها عبارة عن حكم عقلي وبالدرجة الأولى
لذلك نرى أن الولد الصغير يجد صعوبة كبرى في عملية التذكر، لأن الذكرى
ليست صورة بل حكم عقلي عن الصورة المتوضعة في الزمان.
ب- العامل الجسدي:
يتدخل هذا العامل بدوره في عملية التذكر. فموقف الجسد وحركته يجعلان
موضوعًا ما مألوفًا من قبلي. والحدث الذي نعاينه يتخذ أحيانًا معنى متجذرًا
في ذاكرتنا فنراه مألوفًا حتى قبل أن نحكم عليه بالعقل.
ج- العامل الاجتماعي:
وعلى هذا المستوى لا بد من التذكير بنظرية هولباخ التي جاءت في كتابه
“الأطر الاجتماعية” للذاكرة. فبمساعدات الذاكرة حسب هولباخ هي عوامل من
طبيعة اجتماعية. فنحن نعيد بناء الذكريات بالاستناد إلى أحداث اجتماعية
كبرى لأننا نشارك في الحياة الجماعية. فالأعياد والمواسم والدخول إلى
المدرسة كلها نقاط ارتكاز يستند إليها التذكر وتجعل تمييزنا للأمور أشد دقة
ووضوحًا. إنها إضاءات نرسم من خلالها مراحل حياتنا فنحن نقول مثلاً: قبل
الحرب.. بعد حصولي على الشهادة.. بعد زواجي.. فالقبل والبعد هي مرتكزات
تجعل تمثلاتنا للماضي أكثر وضوحًا وانضباطًا. ومن خلال هذه المرتكزات
الموضوعية تتحدد ذاكرتنا الفردية والعائلية أو المجتمعية والوطنية. وعلى
هذا الأساس يقول هولباخ أن الماضي لا يحفظ بل إننا نبنيه انطلاقًا من
الحاضر على أساس المرتكزات الاجتماعية للتذكر.
نخلص من هذا كله إلى أنّ مسألة إعادة بناء الذكريات ترتبط بشخصية الفرد
بكامل أبعاده العقلية والجسدية والاجتماعية. وهذا الارتباط نفسه يؤدي إلى
تغير وتبدّل الذكريات المتأثرة أبلغ الأثر بظروف الشخص الداخلية النفسية
والموضوعية المجتمعية على حد سواء. لذلك يمكننا الكلام على تطور الذكريات.
فالذكريات ليست بأي شكل من الأشكال نسخًا طبق الأصل من الماضي ووقائعه.
والذاكرة ليست آلة تصوير (كاميرا) لأن الذكريات تغتني وتتبدل متأثرةً بكل
الأحداث التي تلت موضوع التذكر.
بهذا الشكل فإننا نرى أنفسنا أمام مسألة إشكالية جديدة تختص بمدى أمانة
الذكريات ولا بدّ من الإشارة سلفًا إلى أن عودة الذكريات العاطفية كاملة،
أي بحذافيرها، هي ظاهرة مرضية أكثر مما هي خاصة بعمليات التذكر عند الشخص
السويّ. فالشخص يمتلك حضورًا أو قيمًا وانشغالات تنم كلها عن حالاته
الحاضرة وتؤثر في عمليات التذكر. وهذا ما عبّر عنه الفيلسوف “غوسد ورف” حين
عنون كتابه “الذاكرة والشخص”، فهو يبين لنا بطريقة صادقة أن الوعي لا
يعكس الماضي ولا يفهمه إلا من خلال القضايا والأوضاع النفسية الراهنة.
إلا أن هناك من يتحدث أيضًا عن ذاكرة عاطفية تكرر الماضي بأمانة كاملة. فهل أن مثل هذه الذاكرة هي موجودة بالفعل؟
الذاكرة العاطفية
الذاكرة العاطفية هي عودة المشاعر على شكل ذكريات. فالأحاسيس والأشياء
تحمل في عمقها معاني تحرك في بعض النفوس مشاعر جميلة أو تعيسة. وللشعراء
في هذا الميدان ذكريات عواطف تغذي أدبهم. ويعتبر الشاعر “بروست” من الذين
توقفوا كثيرًا عند هذا النوع من الذاكرة في كتابه “عودة الزمن”. يقول
“بروست” أنه كان يغمس قطعة بسكويت في الشاي عندما استيقظت في ذاكرته عواطف
جميلة لم يحدد للتوّ هويتها. وتذكر فجأة أيام كان عند عمته في القرية
يتناول الوجبة نفسها. ويذكر أيضًا أنه عند سماعه طقطقة الحطب المشتعل في
موقد، تملّكته مشاعر طفولته في ليالي الشتاء المثلجة.
ولكن ما مدى مصداقية هذه الذاكرة العاطفية؟ وهل هي ذاكرة بالمعنى الدقيق للكلمة؟
صحيح أن الأجواء العاطفية والأشياء القديمة التي تختزن معاني جميلة أو
تعيسة من شأنها أن تحيي ذكريات العواطف القديمة، لكن أنصار هذه النظرية
يدّعون خلاف ما يقرّره علم النفس، معتبرين أن العواطف الجديدة تكرر
العواطف القديمة بتمامها.
أما علم النفس من جهته فهو يقرر أنه كلما طال الزمن فإن عواطفنا تتنامى
وتغتني بتجاربنا، بحيث أن أي موقف جديد يثير ذكريات الماضي لا يمكن أن
تتساوى فيه العواطف الجديدة بالقديمة. فعواطف الكبار هي غير عواطف الأطفال.
وفي حال سلّمنا جدلاً بوجود مثل هذه الذاكرة، فعلينا أن نعترف أن الذاكرة
العاطفية هي شبيهة بالعادات العاطفية، بالتالي فهي تعبير عن حالات مرضية
غير سوية. فالذاكرة العاطفية إما أن تبقى لا واعية فلا تكون ذاكرة، بل
مجرد عواطف مرضية مبهمة أشار إليها “فرويد” في معالجاته النفسية، وإما أن
يرافقها وعي، فتكون العاطفة في هذه الحالة عاطفة جديدة ناتجة عن حالة
تذكر عقلي واعٍ.
النسيان:
يشكل النسيان مفهومًا مضطربًا شأنه في ذلك شأن الذاكرة. فالبعض يعتبر
النسيان غيابًا مؤقتًا أو تأملاً لبعض التمثلات أو الأفكار التي مرّ بها
الوعي. فالنسيان بالنسبة لهؤلاء هو مجرد فقدان أو غياب الذكريات.
ولكن هذا الفهم للنسيان والذي يجعل منه ظاهرة مرضية أصبح مرفوضًا في هذه
الأيام. لذلك علينا أن نميز بين النسيان كظاهرة مرضية والنسيان كظاهرة
عابرة. فالنسيان ليس دائمًا نقيض الذاكرة بل يبدو مكملاً لها.
1- الشكل السلبي للنسيان:
النسيان السلبي يرتد إلى عدم كفاية تثبيت الذكرى ومن أهم الأمثلة على هذا النسيان:
نسيان أحداث السنوات الأولى لطفولتنا. نحن ننسى كل ما لا يثير اهتمامنا
ولا يلفت انتباهنا. فعوامل التقدم في السن والتعب والأمراض، الفيزيولوجية
منها والنفسية، تؤدي جميعها إلى النسيان الذي يتخذ أشكالاً مأساوية
أحيانًا. وللنسيان السلبي أيضًا عوامله النفسية حيث أننا لا نحب استعادة
أخطاء الماضي. فكل الحوادث التي لم نكن نلعب فيها دور البطولة لا نرغب
بتذكرها. ولكن رغم هذا العامل فلا يمكن الادعاء أن للنسيان السلبي دورًا
وظيفيًا في الحياة النفسية.
2- النسيان الوظيفي ذو الطابع الإيجابي:
يوجد شكل آخر من أشكال النسيان إنه الشكل الإيجابي المعبّر عنه بالوظيفي.
فإذا كانت الذكريات تقتضي وجود الاختيار الواعي حتى يتم تثبيتها، فعلينا
أن ندرك أن الذاكرة الجيدة ليست وعاء نضع فيه كل الأحداث دونما تمييز بين
بعضها البعض. فالنسيان بدوره ليس عملية تفريغ لما امتلأت به الذاكرة،
ولكن هو خاضع لعملية الاختيار نفسها التي إما أن تثبت الذكرى وإما أن
تحذفها نظرًا لعدم حيويتها. بهذا المعنى فإن صناعة التذكر تكمن في صناعة
النسيان. فمن دون النسيان الوظيفي لا يمكن قيام ذاكرة حقيقية فالنسيان
الوظيفي هو عبارة عن فقدان الاهتمام بشيء ما، سواء على المستوى العقلي أم
على المستوى العاطفي.
مثال ذلك نحن لا ننسى أبدًا رفاق الصف ولكننا نحتفظ أكثر وأكثر بذكرى
هؤلاء التلامذة الذين كنا نكرههم ولم يكونوا حياديين في نظرنا.
وبالفعل؛ إن النسيان هو شرط لوجود الذاكرة، أي الذاكرة الحقيقية التي
تخلصنا من كل الذكريات التي لا تستدعي اهتمامنا. والشخص الذي لا ينسى هو
عبارة عن آلة أو دماغ الكتروني بينما الشخص السوي هو الذي ينسى ويؤثر
نسيانه على صعيدي العمل والخيال. وعلى سبيل المثال إن ثغرات الذاكرة
وفجواتها هي التي تدفعنا إلى التخيل المبدع وإلى العمل الخلاق.
كذلك فإن للنسيان الوظيفي دورًا فاعلاً في الحياة الأخلاقية وفي القيم.
فالنسيان يعني التسامح وبقدر ما ننسى بقدر ما نكون متسامحين وكرماء.
والواقع أن النسيان يشكل ضرورة عملية. إذ لا يمكن للإنسان أن يتذكر الماضي
بكامل تفاصيله، ولو فعل لأصبح هذا التذكر عبئًا ثقيلاً يعيق حركته في
الحاضر. ولذلك علينا أن نؤكد مع “برغسون” أن الذاكرة هي فعل اختيار يتناسب
مع الحاضر ويتوافق مع مستلزماته.
نخلص من هذا كله أن الذاكرة هي وظيفة وليست مستودعًا تصب فيه الذكريات
وتستعاد كيفما اتفق ومن دون تمييز. ولذلك قيل إن الذاكرة التي لا تنسى لا
تستطيع أن تحفظ. مثل هذا القول لا يقصد فيه مجرد التلاعب بالألفاظ، بل هو
يعبر عن واحد من الشروط المحددة لاشتغال الذاكرة. فالذاكرة هي وظيفة
منظمة تستلزم النسيان. بكلام آخر فإن هذا النوع من النسيان الوظيفي هو
واحد من المقومات الوظيفية للذاكرة، وهو ما أشار إليه “ريبو” بقوله: لكي
نتذكر علينا أن ننسى. وهو كذلك ما جرى على لسان دكتور “ديلاي” حين قال:
النسيان هو حارس الذاكرة.
النظرية التجريبية ومسألة الصورة الذهنية:
يفسّر علماء النفس الكلاسيكي الحياة النفسية باللجوء إلى مفهوم الصورة
الذهنية، أي هذا الأثر المادي المنطبع في الدماغ بعد غياب موضوعات الإدراك.
وقد ذهب أصحاب نزعة التجريب مذهبًا مماثلاً في تفسيرهم لطبيعة التخيّل.
فهم اعتبروا أن التخيّل، شأنه شأن سائر قوى النفس الداخلية، يرتد بطبيعته
إلى الصور أو الآثار المتبقية عن الإدراك الحسي.
وبهذا الشكل فإن كافة أشكال الإدراك والتذكر والتخيّل مستمدة من انطباعات
حسية تشكّل الخطوة الأولى والضرورية التي تسبق كل حالة من أحوال النفس
الداخلية. ومن الأمثلة التي يعتمد عليها التجريبيون لدعم فكرتهم مثال
الأعمى بالولادة الذي ليس بمقدوره أن يتخيّل أو أن يفقه معنى اللون لأنه لم
يسبق له أن عرفه عن طريق الإدراك الحسي. وكذلك هو الأمر بالنسبة للأصم
بالولادة الذي لا يستطيع أن يتخيّل ظاهرة الصوت.
ولا يتوانى التجريبيون عن تفسير التخيل الآخر المعروف باسم التخيّل الخلاق
أو المبدع من منطلق الإدراك الحسي نفسه. فالرسام، على سبيل المثال، في
تخيّله لعروس البحر، لم يبدع هذه الصورة من مختلف جوانبها، وإنما هو أعاد
بناء بعض المعطيات الإدراكية بطريقة مختلفة، أي أنه مزج ما بين صورتين
هما في الأساس من موضوعات الإدراك الحسي؛ إن وجه المرأة وجسم السمكة هما
معطيات حسية، الأمر الذي يعني أن الإدراك هو في أساس كل عملية تخيلية،
وأن التخيل، حتى في أشكاله الراقية والإبداعية، يرتد إلى التخيّل
المستعيد Imagination reproductrice.
مناقشة النظرية التجريبية:
ينطلق التجريبيون في تفسيرهم للتخيل من منظور خاطئ يرد التخيّل والإدراك
إلى طبيعة واحدة. ومن الصعب الدفاع عن هذا المنظور الذي تكذبه التجربة
الشعورية الفطرية. فالتجربة التي يعيشها الفرد في أعماقه يتخللها شعور واضح
بأن التخيّل هو عملية مختلفة عن العملية الإدراكية.
وهذا الأمر تنبّه له بعض فلاسفة التجريب حين ميّزوا بين المتخيّل والمدرك.
فقد اعتبر كل من “هيوم” و “تان” أن الصورة المتخيّلة تختلف عن الصورة
المدركة تبعًا لدرجة القوة أو الضعف التي تسري في الوعي.
بهذا المعنى فإن الموضوع المدرك يكون قابعًا أمامنا بكل تفصيلاته. وفي هذه
الحالة يكون الوعي في أقصى درجات الشدّة والقوّة. أما في حالة التخيّل،
المترافقة مع غياب الموضوع من أمامنا، فإننا نفقد القدرة على الإحاطة
بكامل جوانب الموضوع مما يؤثر سلبًا على مضمون الوعي وقوته.
وعلى هذا النحو فإن هيوم و تان يعتبران أن التخيّل والإدراك هما من طبيعة
واحدة، وأن التمييز بينهما تابع فقط لمعيار القوة أو الضعف. فالإدراك ما
هو إلا حالة من حالات الوعي الناتجة عن صورة قوية تقدّم مضمون الموضوع
بكامل تفصيلاته. أما التخيّل فليس سوى حالة من حالات الوعي الناتجة عن
صورة ضعيفة أُهدرت تفصيلاتها بعد غياب الموضوع.
لكن هذا الحكم الذي يعتبر أن موضوع التخيّل ليس سوى إدراكًا اعتراه الضعف،
لا يأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الطبائع المختلفة لكل من الإدراكات
والتخيّل. وبالفعل فإن الفرق والاختلاف بينهما واضح للعيان. فعلى سبيل
المثال إن إدراك المرء لصورة المنزل الذي يسكنه مختلفة تمامًا عن تخيّله
لقصر فخم. وهذا يعني أن خطأ التجريبيين هو في عدم تمييزهم بين المستويات
المختلفة للوعي. فكل من الإدراك والتخيّل هو مظهر من مظاهر الوعي، أي طريقة
خاصة للوعي في توجهه لمعرفة العالم. فالوعي يمكن أن يكون وعيًا مدركًا،
والوعي يمكن أن يكون وعيًا متخيّلاً، وهذا يعني أن فعل الوعي ليس هو نفسه
إبان عملية التخيّل وإبان عملية الإدراك. فالمذهب التجريبي يقوم بمسخ
الأحداث النفسية وتشويهها عبر ردّها المصطنع إلى أثر مادي أو مضمون.
فالتركيز على مضمون الوعي كان محط الإنتقاد الظواهري الذي بيّن، على خلاف
التجريب، أن مهمة الوعي الأساسية ليست تابعة لمضمونه، لأن الوعي هو أولاً
وقبل كل شيء فعل وحركة قصدية، فهو لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد ألبوم
الصور، بل هو فعل متجه نحو الخارج.
النظرية الفينومينولوجية (الظواهرية) عند سارتر:
تأثر سارتر الوجودي بالغ الأثر بظواهرية هوسرل Husserl وبشيء من مثالية
آلان. فالصورة كما فهمها آلان ليست آثارًا متبقية عن الإدراك. والصورة
الذهنية ليس لها وجود بالمعنى الحقيقي للكلمة. ففي داخلنا وفي أعماقنا ليس
من شيء يصح اعتباره صورة ذهنية. ففي حال التخيّل نقوم فقط بحركات جسمية
وارتسامات لا علاقة لها بالصور الذهنية بل بالجسد وحركاته. فالتخيّل يرتد
حسب آلان إلى مجرّد معرفة بالحركة.
أما هوسرل فقد رأى أن الوعي هو هدفية، ولا يوجد أي شيء داخله، فالوعي لا
يمتلك صورًا ذهنية بل هو مقصور على الفعل والقصدانية. فكل وعي هو فعل
يستهدف شيئًا ما في الخارج، فهو خروج عن الذات باتجاه الموضوعات. بالتالي
فإن الوعي ليس حاويًا لا للصور ولا للذكريات، بل يصح اعتبار الصور
والذكريات مواقف يتخذها الوعي بإزاء موضوعات الخارج.
ومن خلال تأثره بآلان وهوسرل يباشر سارتر بالوصف الفينومينولوجي للوعي
المتخيّل. فالأمر المتخيّل ليس هو الأمر المدرك. إنهما طريقتان مختلفتان
لاستهداف موضوع ما. وخلال عملية الإدراك يكون الموضوع ماثلاً أمامي، أما في
لحظة التخيّل فإن الموضوع يكون غائبًا. فلكي أتخيّل موضوع ما، علَيّ أن
أعتبره غير موجود، أي عدمًا. إن تخيّلي لشخص ما ليس بمعرفة تتم عبر اللمس
أو الرؤية، وإنما هي طريقة في المعرفة تلجأ أساسًا إلى غياب الشخص وإلى
فقدان كل مسافة مكانية بيني وبينه. ومهما كانت قدرتي على التخيّل قوية،
فإن التخيّل يتعاطى دائمًا مع الأشياء والموضوعات من حيث غيابها. لذلك
فإن الصورة المتخيّلة عند سارتر ليست من طبيعة الإدراك الحسي. ففي حال
الإدراك يمكن التعمق في معرفة أدق تفاصيل الموضوع، بينما في حال الصورة
التخيلية فإنها تأتي إلى الذهن دفعة واحدة. والصورة المتخيّلة لا يمكن
إغناؤها بأية تفاصيل، بل هي تتمتع حسب سارتر بميزة الافتقار إلى
التفاصيل.
فعلى سبيل المثال حين أتخيّل صديقي فأنا لا أستدعي صورته بل أستهدفه
كموضوع غائب. ولكن إذا كان التخيل عبارة عن غياب الموضوع، ألا يعني هذا
الأمر أن التخيّل والمعرفة قد أصبحا شيئًا واحدًا؟ وهل يجوز أن يصبح
التخيّل مجرد معرفة؟
في ردّه على هذا الاعتراض يؤكد سارتر أن التخيّل ليس مجرد معرفة، وأن فعل
التخيل ليس هو نفسه فعل التفكير. فالمعرفة تستهدف موضوعًا غائبًا وتستهدف
الأفكار المجردة والمفاهيم، بينما التخيّل يفترض وجود مادة، أي هيولى
يستطيع الوعي المتخيّل من خلالها استهداف موضوع ما. فالشاب المولع بحبيبته
لا يتخيّل محبوبته من خلال معرفة مجردة، بل يفكر فيها من خلال مماثل مادي
analogon يمكن أن يكون صورة فوتوغرافية أو حركة أو هدية.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن المماثل عند سارتر ليس موضوعًا واقعيًا، لأن
التخيّل لا يحصل بالفعل إلا بعد غياب المماثل، أي حين يفقد المماثل حضوره
ويصبح مجرد رمز. فالصورة الفوتوغرافية ليست هي المعتبرة في عملية
التخيّل، بل دلالتها أو ما ترمز إليه. بهذا الشكل فإن سارتر قد قلب مفهوم
النظرية التجريبية رأسًا على عقب، بحيث لم يعد التخيّل الإبداعي مردودًا
إلى التخيّل المستعيد وتابعًا له. كذلك فإن الإدراك لم يعد أساس
التخيّل، بل أصبح الإدراك نفسه مربوطًا بمقدرة الشخص على التخيّل.
أشكال التخيّل:
يتخذ التخيّل أشكالاً متعددة ترتد كلها إلى مستوين:
مستوى الأشكال الدنيا ومستوى الأشكال العليا. أما الأشكال الدنيا للتخيل
فتتوزع ما بين تخيّل فوضوي هائم وتخيّل طفولي حالم ثم أحلام اليقظة. أما
الأشكال العليا فتتركز فيما يُطلق عليه اسم التخيل المبدع الذي يفتح آفاق
الإبداع الإنساني في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية.
أ- الأشكال الدنيا للتخيل:
ونبدأ بالأشكال الدنيا (inférieure) حيث يبدو التخيل الهائم (errante)
تخيلاً فوضويًا غير منضبط بقوانين، وغير خاضع لأية قواعد. فالتخيل الهائم،
وإن استمد بعضًا من صوره من الواقع، إلاّ أن ما يميزه كونه أشبه بحال
الهذيان وبفوضى الأحلام، وهو بالتالي غالبًا ما يعبر عن حالة مرضية. ففي
حالة الحلم تعمّ الفوضى وتتواجد الأشخاص والأماكن والأشياء عشوائيًا
وبطريقة غير منطقية، فيكون الشخص الواحد هنا وهناك في آن معًا. وفي الحالات
المرضية يسيطر كذلك التخيل المرضي فيأتي بصور مرتبطة برغبات أكثر مما هي
مرتبطة بالواقع ومجرياته بالتالي فإن الفرد الذي يمارس هذا النوع من
التخيل الهائم والفوضوي هو شخص غير سوي أهمل الواقع واستغرق في أوهامه
الخاصة.
والتخيل الطفولي (infantile) هو بدوره أحد أشكال التخيل الدنيا. فالطفل
يحوّر الوقائع ويكوّن عالمًا خاصًا به تسيطر عليه أوهام النزعة الإحيائية
(animisme). فالفتاة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات من العمر، تتخيل أن
الحجارة المتواجدة في الطريق يعتريها الضجر، شأنها شأن الناس الأحياء.
ولذلك تراها تحمل بعض هذه الحجارة وتنقلها من مكانها إلى مكان آخر كي
تخلصها من الضجر. وفي كثير من الأحيان يتحول خيال الطفل إلى خيال أسطوري،
ويخترع الولد بعض القصص الخيالية وينسج أحداثها وربما جعل من نفسه أحد
أبطال هذه القصص. والجدير ذكره أن هذا العالم الخاص يبتدعه الولد نظرًا
لتعلقه بعالم الغرائب والعجائب، وهو يجد أن هذا العالم الخيالي أكثر واقعية
من عالم الكبار والراشدين.
أما أحلام اليقظة (rêverie) فهي تشبه في بعض من وجوهها التخيل الهائم
والفوضوي، لكنها أقرب إلى الفطرة والبساطة. فمن خلال أحلام اليقظة يترك
الفرد نفسه منقادة لسجيتها، ويجعلها منفلتة من كلّ القيود والضوابط
المجتمعية، بالشكل الذي تغيب معه كل وظائف المراقبة عن ممارسة فعاليتها في
الضبط والتوجيه.
وأحلام اليقظة، التي تفتح أمام الشخص أبواب الخيال الجانح، تؤدي إلى عدم
تركيز الوعي على الواقع الراهن الماثل أمام الشخص. وهذا ما يسميه لالاند
حالة الضياع والتشتت. لكن هذا الضياع له مستويات ودرجات متعددة، وهي تختلف
عن حالة الفوضى المشاهدة في الأحلام الليلية فبينما نجد أن الحلم الليلي
يجري من دون التركيز على موضوع واحد بعينه، فإن أحلام اليقظة تتركز على
موضوع واحد تعود إليه المرة تلو الأخرى لتنير جوانبه. فأحلام اليقظة يمكن
أن تلعب أحيانًا دوراً إيجابيًا ومبدعًا. ولكنها في أحيان أخرى تصبح في
غاية الخطورة لأنها تسلب الفرد القدرة على المشاركة في هموم الواقع فتقضي
على حياته السويّة وتستبدلها بأوهام زائفة.
ب- الأشكال العليا للتخيل أو التخيل الإبداعي:
يمكن القول أن الإبداع والاكتشاف هما من أهم الأشكال العليا للتخيل.
والإبداع يختلف عن الاكشتاف. فالإبداع هو الإتيان بجديد لم يكن موجودًا من
قبل، بينما الإكتشاف يختص بالكشف عمّا كان موجودًا، ولكن وجوده كان
مستترًا ويعتريه الغموض. فغاليليه دخل عالم الإبداع في اختراعه للمنظار
الفلكي، وغاليليه نفسه هو من المكتشفين لأنه اكتشف وجود الكوكب جوبيتر.
والواقع أن الاختلاف بين الإبداع والإكتشاف ليس اختلافًا جذريًا. فكل
إبداع هو اكتشاف، وكل اكتشاف هو إبداع وذلك لسبب بسيط وهو أن الإبداع
الأكثر جدةً لا ينطلق من لا شيء، بل لا بدّ له من الارتكاز إلى أفكار
ووسائل قديمة وسابقة عليه.
إن الجديد في عملية الإبداع ليس جدة العناصر بل الجديد يختص بالمنهج أو
بإعادة تركيب العناصر القديمة بأشكال مختلفة وفي منطلقات منهجية جديدة. فكل
إبداع وكل إكتشاف يفترض باستمرار مناهج جديدة وطرائق جديدة في تفسير
الأمور. فالاكتشاف هو طريقة جديدة في النظر إلى الأمور وهو في أغلب الأحيان
يتأتى من خلال علاقة جديدة:
شروط ومرتكزات التخيل الإبداعي:
1- المرتكزات العاطفية:
يفترض بالشخص المبدع أن يتمتع بادئ ذي بدء ببعض الخصائص العاطفية.
فالعالم، شأنه شأن الفنان والشاعر، يتمتع بحسّ مرهف يجعله في حالة تيقظ
ويشد انتباهه صوب بعض الموضوعات المتميزة.
والواقع أن الإبداع يرتبط بالإندفاع العاطفي وبالحماس أكثر بكثير مما
يرتبط بالطرائق أو الوسائل المتبعة. فالعبقرية وثيقة الصلة بالقلب
وبالإنفعالات العظيمة الخلاّقة حسب التعبير البرغسوني.
2- المرتكزات العقلية:
لا شك في أن الإبداع هو عبارة عن عملية عقلية لأنه يرتكز بالدرجة الأولى
على التجريد والتعميم، كما يعتمد على الفكر النقدي والمنهجي.
ولكن كلود برنار يبيّن أن دور العقل في الإبداع لا يقتصر على اتباع
الطرائق، إذ أنه في الكثير من الأحيان يتم الكشف عن الحقائق الجديدة عبر
الحدس أو الإستنارة الفجائية التي تتخطى اتباع طرائق البحث ومناهجه. مع ذلك
ورغم هذا الطابع الفجائي للإبداع، ينبغي الإقرار بأن الإبداع ليس وليد
الصدف أو العبقريات الفريدة من نوعها، بل هو نتيجة منطقية للأبحاث
المستمرة وللعمل الدؤوب. فالحقيقة أنّ ما يبتدى كإبداع فجائي من دون
مقدمات ليس إلا النتيجة الفعلية للكثير من الأبحاث التي جرت في السابق من
دون التوصل إلى نتائج، فكانت بالتالي خطوة تحضيرية وتأسيسية سابقة لكل
عملية إبداعية.
3- المرتكزات الاجتماعية:
يرتبط تاريخ العلم بالعديد من أسماء العلماء البارزين مما يساعد على
الاعتقاد أن عبقرية الأشخاص ومبادراتهم الفردية لها دور بارز في الاكتشافات
العملية وفي الإبداع. ولكن لا يخفى ما في هذا الاعتقاد من تضخيم لدور
الفرد، إذ الفرد نفسه ينتمي إلى مجتمع معين وعصر معرفي يستمد منهما ثقافته
ومعارفه العلمية. فمسألة الإبداع مربوطة بحالة العصر المعرفية. وكل
اكتشاف أو إبداع لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت الحالة المعرفية تسمح
بحصوله. فالعبقرية حسب لوروي Le Roy ليست وليدة الفطرة بل هي متأتية من
التعلم والاكتساب. فالفنان لا يبدع إذا هو لم يطلع على مدارس الفن
ومذاهبه، والرسم يتم تعلمه في المتاحف على حد تعبير (Renoir).
وعلى هذا النحو يظهر أن الإبداع ليس نتيجة عمل فردي وإنما هو نتيجة لتضافر
العديد من الجهود والعبقريات، أو بالأحرى هو نتيجة لإسهام العديد من
الأجيال المتعاقبة. والواقع أن التطور العلمي المعاصر لم يعد مرهونًا
بأفراد، بل بعمل المجموعات والمؤسسات ومراكز الأبحاث الكبرى التي تضم
أعدادًا كبيرة من الباحثين من مختلف أصقاع العالم.


